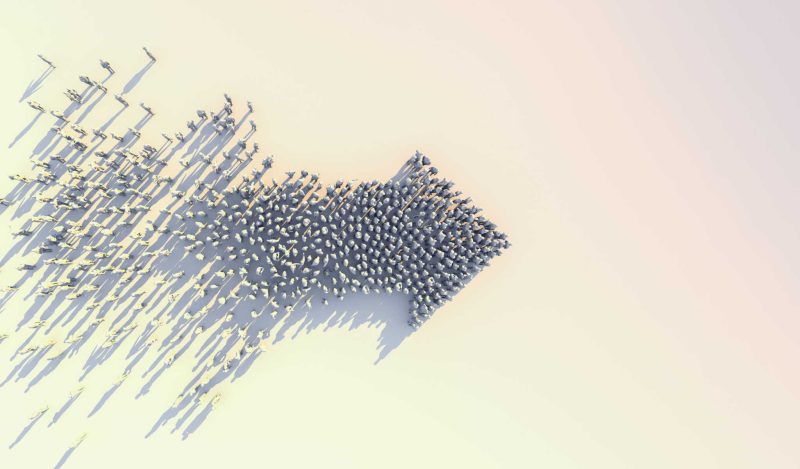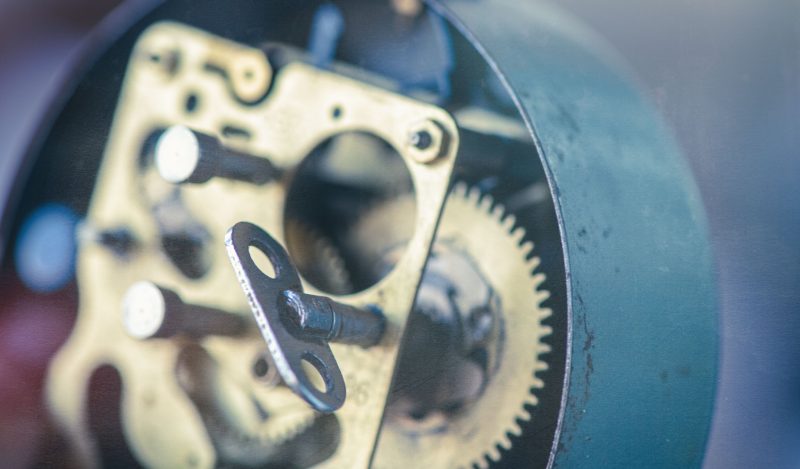باستثناء ما تبقى من الجيل الصامت (المولود قبل عام 1946) ، فإن الجيل X هو "الأصغر" بين الأجيال على قيد الحياة اليوم. يوجد عدد أقل منا من جيل الطفرة السكانية أو جيل الألفية أو الجيل زد. أتساءل أحيانًا إلى أي مدى يساهم كوني من بين أصغر أقلية من الأجيال في زيادة شعوري كأنني غريب في أرضي.
ربما تكون بعض أسباب شعوري بالاغتراب الثقافي غير مفاجئة ...
أنا لا أعيش على وسائل التواصل الاجتماعي.
أفضل البساطة على التكنولوجيا والحياة في ثلاثة أبعاد على التمثيل المنسق لها في بعدين.
لا ألتقط صوراً لنفسي أو أنشر تفاصيل عن حياتي الشخصية لأولئك الذين لم يطلبوها صراحةً.
أنا مرتاح تمامًا في رجولتي.
أضحك على النكات غير الملونة دون أي مسحة من الذنب.
أعتقد أن الإهانة يتم أخذها دائمًا ولا تُعطى أبدًا - لذلك لا أشعر بالإهانة.
أغتنم الفرص للانخراط في الأفكار التي تجعلني غير مرتاح لأنني أجد أنها توفر أفضل الفرص للنمو ؛ أنا أشفق على أولئك الذين يتجنبون مثل هذا الانزعاج.
أنا أستمتع بحجج الضربات القاضية حول القضايا التي تهمني ولا تأخذها على محمل شخصي.
سأقدم الجوائز فقط للفوز.
أنا مستاء من رسالتي السياسية عند ذهابي إلى عملي اليومي ، مثل شراء البقالة أو ركوب الحافلة.
أعتقد أن التنوع الوحيد الذي يهم حقًا هو المنظور ، وآسف أن الخطاب السائد حول التنوع ، ومن المفارقات ، غير متنوع وعديم الخيال.
لن أطلب أبدًا من أي شخص أن يتحدث عني باستخدام كلمات غير تلك التي يختارونها ، لأنني أعتقد أن حرية الفكر - حتى حرية مناداتي بالأحمق من أي جنس - هي أكثر أهمية من جعل الناس يتظاهرون باحترامي.
وأواجه معظم ما سبق كجزء من كوني بالغًا ناضجًا عاطفيًا.
كوني إنسانًا ، بالطبع ، سأكون أكثر سعادة إذا لم تكن هناك اتجاهات ثقافية كثيرة اليوم تعارض ميولتي وتفضيلاتي. حقيقة أنها تثير قلقي العميق ، لم تجعلني أفقد الأمل أو أتوقف عن العمل لتعزيز قيمي في المجتمع ككل.
ومع ذلك ، فأنا الآن أقل تفاؤلاً مما كنت عليه في أي وقت مضى - بسبب ظاهرة أكثر عمومية وأساسية من أي اتجاه سياسي أو ثقافي أو قضية في عصرنا.
يبدو لي الآن أن شرطًا ضروريًا وكافيًا في النهاية لتدمير كل ما هو جيد في طريقة الحياة الغربية وكل ما يضمن التعايش السلمي مع الآخرين قد تم الوفاء به بالفعل.
إنه شرط الاجتماع الذي هو شرط لا غنى عنه لجميع الاتجاهات الثقافية والسياسية المدمرة بشكل كبير في عصرنا. إنها حالة يمكن أن يؤدي اجتماعها إلى عكس التقدم الأخلاقي والفكري. وهي حالة محصنة ضد المقاومة المؤسسية أو الانقلاب لأنها تعيد تشكيل المؤسسات ، كما هي في أذهان الأفراد الذين يقطنونها. إنها حالة أخلاقية - لا تتعلق بأي ادعاء أو سؤال أو سلوك أخلاقي معين ، بل تتعلق بالمعنى والخبرة الأخلاقية على الإطلاق.
وبالتحديد ، إنه التلاشي الواضح للتجربة وفكرة الأخلاق الشخصيةمقيد خاصة الفرد وجهات النظر والكلام والأفعال - واستبدالها بتجربة وفكرة عن الأخلاق الموضعية، معنية بتقييد الآراء والكلام والأفعال من الآخرين.
هذا الضعف الشخصية تتجلى الأخلاق مرارًا وتكرارًا على أنها جبن أخلاقي في مواجهة السياسات والممارسات التي تسبب عدم ارتياح للضمير عندما تأتي مقاومتها على حساب شخصي. على نحو متزايد ، يبدو الغربيون المريحون في العالم الناطق باللغة الإنجليزية مستعدين وقادرين على تبرير التنازلات الأخلاقية التي يقدمونها عندما يمتثلون - وبالتالي يضفيون ثقل وكالتهم الأخلاقية على - المعايير الاجتماعية والثقافية والتوقعات والتفويضات التي تسيء إلى القيم التي يرغبون في الاعتقاد بأنها تحملها.
مثل هذا الجبن الأخلاقي ، عندما يكون في كل مكان بما فيه الكفاية ، قد يكفي وحده لتدمير المجتمع ، ولكن ربما لا يكون كذلك. تستدعي مثل هذا الدمار بقدر ما السماح هو - هي. لا يتم ضمان تدمير أسلوب حياة إلا عندما تسيطر الأخلاق الموضعية للأقلية على الثقافة لأن الأغلبية الجبانة أخلاقياً تختار الراحة على الضمير وتلتزم.
تؤثر الأخلاق الشخصية على الآراء السياسية للفرد وتقيدها لأنها تحترم الوكالة الأخلاقية ، وبالتالي القيمة الأخلاقية للآخرين. على النقيض من ذلك ، فإن الأخلاق الموضعية لا تحترم - أو حتى تنكر - وكالة الآخرين لأنها تحدد الأخلاق فقط وفقًا لمواقفها.
ينجح هؤلاء المخلصون الموضعون الذين سيخبرون البقية منا بما يجب عليهم فعله طالما أن بقيتنا يمتثلون لمطالبهم ضد حكمنا الأخلاقي الأفضل. نفعل ذلك عندما تكون أخلاقنا الشخصية أضعف من أن تدفع ثمن عدم الامتثال.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يصوتون للقادة الذين يعرفون أنهم تصرفوا بطرق يعتبرونها غير أخلاقية - وكانوا يؤدبون أطفالهم على الظهور.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين ينتقدون غير الأعضاء في المجموعة التي يتعرفون عليها بسبب أفعال أو وجهات نظر لا يحبونها ، ومع ذلك لا يصدرون أي حكم على أعضاء مجموعتهم لإظهارهم نفس الإجراءات أو الآراء.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يؤمنون بحرية التعبير ومع ذلك يتماشون مع متطلبات التصريح بالكلمات التي يجب أن يستخدمها الآخرون للإشارة إليهم.
أنا أتحدث عن أولياء الأمور الذين يقلقون بشأن إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال ومع ذلك لا يتدخلون عندما يرون ذلك يحدث بالضبط في مدارسهم.
أنا أتحدث عن التربويين المهتمين بتوسيع العقول ومع ذلك يقفون متفرجين عندما تمنع مؤسساتهم ، أو الأشخاص الموجودون داخلهم ، بنشاط أولئك الذين يرغبون في سماع حجة غير تقليدية من القيام بذلك.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يقفون مكتوفي الأيدي لأن معاني الكلمات التي استخدموها طوال حياتهم قد تغيرت من خلال التشريعات لأغراض سياسية ، ويعاقب آخرون أو يضطهدون لاستخدامها مع معانيها الأصلية والمشتركة.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين لن يعترفوا علنًا أن شيئًا ما ضحكوا عليه في السر يمكن أن يقال بشكل مقبول لهذا السبب بالذات.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يقبلون بسعادة العودة كامتيازات لأنفسهم عما اعتادوا اعتباره حقوقًا للجميع.
أنا أتحدث عن الأشخاص الذين يؤمنون بالاستقلالية الجسدية لكنهم يقبلون التدخل الطبي الإجباري للحفاظ على وظائفهم.
في حين أن الأخلاق الشخصية تقيد كيفية معاملة المرء للآخرين ، الموقفية تسمح الأخلاق للناس بمعاملة الآخرين معاملة سيئة بقدر ما يختارون طالما أن الآراء التي يشرحها هؤلاء الأشخاص تعتبر "غير مقبولة".
في حين تتطلب الأخلاق الشخصية تمسك الفرد بالضمير واحترامه في الآخرين ، تتطلب الأخلاق الموضعية ، بل وتكره ، انتهاك الضمير من قبل الآخرين إذا كانت مخرجات ضمائرهم تعتبر "غير مقبولة".
نظرًا لأن كل من عمل الضمير والالتزام به يتطلب التزامًا بالحقيقة ، فإن الأخلاق الموضعية تتطلب تكمن من الأشخاص الذين يقودهم التزامهم بالحقيقة إلى مثل هذه الآراء "غير المقبولة".
يمكن أن تكون الأخلاق معقدة وصعبة ودقيقة لأنها تنطبق على جميع التعقيدات والاختلافات في تجارب البشر المعقدة التي لا تعد ولا تحصى. غالبًا ما يفضل الجادون من الناحية الأخلاقية عدم اتخاذ موقف حازم بشأن قضية لها جوانب عديدة ، خاصة عندما يكون لمثل هذا الموقف آثار أخرى تثير المزيد من الأسئلة المبدئية أو صعوبات التنفيذ. على النقيض من ذلك ، فإن الأخلاق الموضعية - وهي نوع من الأخلاق الزائفة المجوفة - لا تعلق بالعملية الشخصية العميقة للتفكير الأخلاقي: فهي تحكم على الناس بناءً على تبنيهم لمواقفهم المفضلة أو فشلهم في تبنيها.
يطرح سؤال مثير للاهتمام فيما يتعلق بكيفية وصولنا إلى هنا: ما هي العوامل التي غيرت تجربة وفكرة الأخلاق بالنسبة للعديد من الأفراد إلى شيء يقيد ويحكم ليس على أنفسهم بل على الآخرين؟
السؤال أكبر من أن يجيب عليه: هناك الكثير من المتغيرات والعوامل ، المعروفة وغير المعروفة ، التي يتعذر تحديدها قبل إعطاء أي إجابة مرضية عن بُعد ، ولكن هناك نقطتان عامتان جدًا توحي بوجودهما.
أولاً ، بدأ واضعو الأخلاق الموضعية في الاستيلاء على أنظمة التعليم العام منذ جيلين ، والآن (بافتراض وجود علاقة ارتباط قوية بين الأخلاق الموضعية والالتزام بالإيديولوجيات اليسارية التي تستخدم صراحة مثل هذه الأخلاق لتبرير أهدافها السياسية) يمثلون أغلبية ساحقة من جميع المعلمين ، بما في ذلك ، خاصة الأكاديميين في العلوم الإنسانية.
ثانيًا ، يتمتع واضعو الأخلاق الموضعون بملكية وسيطرة غير متناسبة على مرتفعات القيادة الثقافية لوسائل الإعلام والتكنولوجيا الكبيرة والتعليم (لا يزال). وهم يسيطرون على المنصات الأكثر نفوذاً ، ويستخدمونها بنشاط لفرض رقابة على وجهات النظر التي تتعارض مع مناصبهم المعتمدة ، ولتعزيز وجهات نظر أصدقائهم في الحكومة ووكالاتها ، حيث يتم العثور على أقوى واضعي الأخلاق المناصبين غير الخاضعين للمساءلة على الإطلاق.
هذه الظواهر (الواسعة جدًا) (من بين العديد من الظواهر الأخرى) من المحتمل أن تكون قد مكنت ، وتساعد الآن في الحفاظ ، على الثمن الباهظ الذي يجب دفعه مقابل الشجاعة الأخلاقية والمكافأة مقابل الامتثال. لقد فعلوا ذلك ، جزئيًا ، من خلال إسكات أولئك الذين يحاولون التمسك بالقيم الأساسية التي كانت حتى سنوات قليلة مضت تعتبر بحق تلك القيم التي يعتمد عليها البقاء السلمي لمجتمعنا ورفاهية المجتمع. من جميع من أعضائها تعتمد. تشمل هذه القيم الأساسية الالتزام بالحقيقة والحرية والاحترام المتساوي لوكالة وضمير كل فرد ، أينما يقودها بإخلاص.
لحسن الحظ ، لا نحتاج إلى أن نفهم بتفصيل كبير كيف وصلنا إلى هنا لنكون قادرين على حل المشكلة. مثلما يعتمد تدهور مجتمعنا وقيمه ، مهما كانت العوامل المساهمة ، على امتثال عدد كافٍ من الأفراد ، فإن عكسه يعتمد ، من الواضح ، على عدم الامتثال ، أي الشجاعة الأخلاقية.
الشجاعة الأخلاقية محفوفة بالمخاطر: لها ثمن ، وهذا هو سبب تسميتها شجاعة. كما أعلن أرسطو ، "الشجاعة هي الفضيلة الأولى لأنها تجعل كل الفضائل الأخرى ممكنة." إذا كان هذا صحيحًا ، وكان كذلك ، فإن القدرة على عكس المحاولات لإعادة تشكيل المجتمع الغربي إلى مجتمع خالٍ من القيم الأخلاقية الأساسية التي تمكن من جميع الأفراد لتحقيق الازدهار السلمي يكمن في النهاية - وفقط - في الداخل كل الفردية.
من أين تأتي هذه الشجاعة؟ إنها تأتي من صفة شخصية على الإطلاق ، تسمى النزاهة.
يمكن للسياسيين وعلماء الاجتماع والنقاد الإشارة جيدًا إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تدفع التغيير المجتمعي - لكن كل تغيير من هذا القبيل يتم توسطه من خلال اختيارات الأفراد. عندما يثقل البديل الأفضل وفقًا للضمير الشخص الذي يختاره ، فإن اختيار هذا الشخص يتقلص إلى واحد: أن يكون متواطئًا أو شجاعًا.
في معظم الأوقات ، أثناء قيامنا بعملنا ، لا نواجه مثل هذه الخيارات ، ولكن بشكل متزايد هذه الأيام يواجه الأشخاص العاديون مواقف يكون فيها شيء من الأهمية الأخلاقية على المحك وهم يعرفون ذلك في قلوبهم (بنفس القدر) كما يحلو لهم لم يفعلوا).
في تلك الأوقات ، يكون لرفض التوافق مع بعض المعايير أو التوقع أو الطلب ثمن شخصي ويتطلب شجاعة ، بينما السير على طول الطريق يجعل الحياة أسهل ، ولكنه أيضًا يُعلن عن الفاعلية الأخلاقية للفرد ، وبالتالي يمكن القول إن القيمة الأخلاقية للفرد ، تستحق أقل من هذا السعر.
في تلك الأوقات ، لا يوجد حل وسط: يمكن للمرء أن يختار بديلاً يساهم في استمرار الحالة اللاأخلاقية أو بديل يساهم في إنهائها.
لذلك ، في تلك الأوقات ، الامتثال هو أن تكون متواطئًا.
ولكي نكون متواطئين - كما هو الحال بالنسبة للكثيرين منا في كثير من الأحيان اليوم - يعني أن نكون مسؤولين أخلاقيا ، وعاملا لإحباط الغرب الذي لا رجعة فيه (في كلا الحالتين).
نشرت تحت أ ترخيص Creative Commons Attribution 4.0
لإعادة الطباعة ، يرجى إعادة تعيين الرابط الأساسي إلى الأصل معهد براونستون المقال والمؤلف.