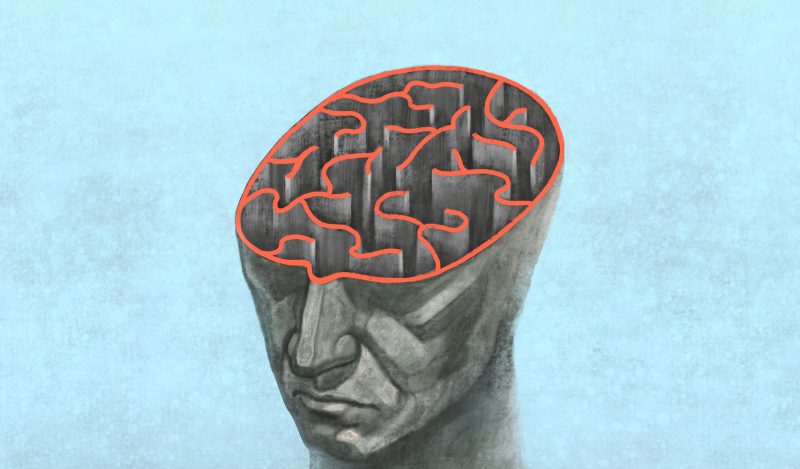لا أعرف عنك ، لكنني تعلمت منذ فترة طويلة كيف أتعرف على الوقت الذي كنت أعاني فيه من البرد أو الأنفلونزا ، وأفضل السبل لمنع نفسي والآخرين من المعاناة من أكثر آثارها ضررًا.
لقد طورت المعرفة في هذا المجال بمجرد مشاهدة الآخرين والاستماع إليهم ، ثم التحقق من هذه المدخلات النظرية مقابل ردود الفعل التي يمكن ملاحظتها وسلوكيات جسدي.
لا أعتقد أنني فريد في هذا. أعتقد أنه إذا تُرك لأجهزتهم الخاصة ، يمكن لمعظم الناس تحديد الفرق بين التهاب الحلق مع سيلان الأنف والاضطراب الذي قد يهاجم أجسادهم بطريقة أكثر جدية ومنهجية.
ربما ينبغي علي تصحيح نفسي. أعتقد أن حتى 22 شهرًا مضت يمكن لمعظم الناس الانخراط بثقة في عملية التمييز هذه التي تم شحذها بمرور الوقت. الآن لست متأكدًا من أن هذا هو الحال.
ما الذي تغير؟
ما تغير هو أنه كانت هناك حملة نفسية منسقة لإدخال نماذج مرضية مجردة وغالبًا ما تكون مشكوك فيها تجريبياً. ما بين المواطنون الأفراد وفهمهم لأجسادهم ، النماذج المصممة صراحة لإزالة مركز السيطرة عن ذلك المواطن وغرائزه وإيداعها في أيدي مجموعة من السلطات الطبية والحكومية.
كتب José Ortega y Gasset: "من المفيد على عدة مستويات فهم هذا التناقض: تتطلب هذه الرؤية بالضرورة تعاون درجة معينة من العمى". "أن نرى أنه لا يكفي أن توجد ، من جانب ، أعضاء بصرنا ، ومن ناحية أخرى ، الكائن المرئي يقع ، كما هو الحال دائمًا ، بين أشياء أخرى مرئية بشكل متساوٍ. بدلاً من ذلك ، يجب أن نقود التلميذ نحو هذا الشيء بينما نحجبه عن الآخرين. لنرى ، باختصار ، من الضروري التركيز ".
إذا نظرنا إليها من منظور استعارات البصر ، فيمكننا القول إن العدسة المشوهة التي توفرها القوى الخارجية التي تركز بشكل كبير على الضعف والاعتماد بدلاً من المرونة تتوسط الآن ، وبالتالي تعيد تشكيل ، العلاقة التي تربط الملايين من الناس بعلاقاتهم الخاصة. الإحساس بالصحة ، فضلاً عن شعور مواطنيهم.
كانت الآلية المستخدمة للتأثير في هذا الاغتصاب الهائل للثقة الفردية والغريزة ، بالطبع ، الاختبارات الجماعية التي منحت للحكومة والمسؤولين الصحيين المختارين ما يقترحه غابرييل غارسيا ماركيز في مئة عام من العزلة هي واحدة من أعظم القوى الثقافية للجميع: القدرة على التسمية.
ما كان حتى أوائل عام 2020 هو مجموعة من الأعراض التي تم تحديدها بشكل فضفاض وغير دقيق تحت عنوان "نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية" ومن المتوقع أن تعيش كمسألة شخصية دائمة وغير ملحوظة ، مع بداية الاختبار الشامل لم يتم إعطاؤها فقط الاسم - مع الاحتمالات الجديدة للتسليح والأساطير التي تجلبها هذه العملية دائمًا - ولكنها مشبعة بحضور طيفي شامل.
مرة أخرى ، النموذج المستخدم لإنشاء وتبرير الحرب على الإرهاب مفيد هنا. قبل بدء تلك الذريعة التي لا تنتهي لإبراز القوة الأمريكية ، كانت الحرب تهتم إلى حد كبير بالجنود الذين تم تعريفهم من حيث علاقتهم المعارضة بالمدنيين. الأولى كانت لعبة عادلة كأهداف للهجوم ، لكن الثانية ، على الأقل من الناحية النظرية ، لم تكن كذلك.
ما فعلته الحرب على الإرهاب هو إعادة تعريف كل شخص في العالم ، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين ، على أنهم الجنود المحتملين ضد كل ما اعتبرته حكومة الولايات المتحدة جيدًا وصحيحًا. كيف تم ذلك؟ من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن الجميع - الاستخبارات ، بالطبع أن "المسؤولين الحكوميين" فقط لديهم القدرة على الرؤية والتلاعب - تحولنا جميعًا إلى مشتبه بهم ، أو إذا كنت تفضل ذلك ، إلى ما قبل المجرمين.
بعد كل شيء ، هل هناك أي شخص منا لا يمكن جعله يبدو "مشبوهًا" وبالتالي يستحق الهجوم (سواء كان ذلك في شكل اغتيال شخصية أو تشويه استراتيجي أو فخ قانوني صريح) من قبل مجموعة من الأشخاص مع سيطرة تحريرية كاملة من أدق تفاصيل حياتنا الشخصية؟
قبل ربيع عام 2020 ، كان المرء إما مريضًا أو بحالة جيدة وفقًا لمقاييس تجريبية مفهومة منذ زمن طويل. ولكن مع ظهور الاختبارات الجماعية للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض (مع اختبار مصمم لتوليد العديد من الإيجابيات الزائفة) ومعها ، "الواقع" المصمم جيدًا ، وإن كان ملفقًا تمامًا ، للانتقال بدون أعراض ، اكتسبت النخبة القدرة الفورية على تصوير ملايين من نحن "مرضى" ، وبالتالي كتهديدات خطيرة محتملة للرفاهية العامة ، وبالطبع ، من المحتمل أن نستحق عقوبات قاسية.
وقد نجحت. والآن فإن الشك والخوف المعمم الذي كانوا يأملون في تطويره فينا مستقر بعمق في أدمغة معظم الناس ويؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمعية بطرق دقيقة للغاية.
النتائج في كل مكان حولنا لنرى. قبل أسبوع ، في عيد الميلاد ، كنت أعاني من سيلان في الأنف والتهاب في الحلق. في السنوات الماضية ، قبل أن يتم إعطاء مثل هذه الأشياء المبتذلة اسمًا وتشبعها - في تناقض تام مع جميع الأدلة التجريبية - بقوى تدمير أسطورية ، كنت سأكون قد اتخذت قرارًا شخصيًا ، متأصلًا في معرفتي بجسدي ، والحس السليم فهم الخطر الذي قد أفعله أو لا أفعله للآخرين ، أو الذهاب أو عدم الذهاب ، تجمع العائلة في منزل أختي. وكانت ستحترم كل ما تقرر فعله.
ولكن الآن ، بفضل شبكة اكتشاف ما قبل الجريمة / ما قبل المرض التي تم تمكينها من خلال الاختبارات الجماعية ، أصبح الزكام الآن مسألة مجتمعية خطيرة. ماذا لو كنت "إيجابية" ونقلتها إلى ابن أخي؟ ثم ، الذي "يُحاكم" باستمرار بسبب مرض ما قبل المرض كجزء من نظام المدرسة الجديد ، لن يتمكن من الذهاب إلى المدرسة لعدة أيام.
تم تجنب حساب التفاضل والتكامل تمامًا في مثل هذا السيناريو هو حقيقة أن ابن أخي إذا كان إيجابيًا قد لا يكون قريبًا من المرض كما يُحكم عليه بالوسائل التجريبية ، أو ما إذا كان - في حالة شمسي كان مرتبطًا بطريقة أو بأخرى بالفيروس الميثولوجي الآن - يمكن أن يكون لها أي آثار خطيرة طويلة المدى عليه أو على زملائه في الفصل أو على معلمه. لا ، الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره مهمًا هو "واجب" المدرسة في ممارسة الفصل باسم مفهوم الأمان الغامض وغير القابل للإثبات من الناحية التجريبية.
ثبتت إصابة أحد أفراد الأسرة الشاب الآخر بالقرب من عيد الميلاد وطلب منه صاحب العمل البقاء في المنزل. معقول بما فيه الكفاية.
لقد كان خاليًا تمامًا من الأعراض الآن لمدة أسبوع على الأقل. لكنه لم يتمكن بعد من العودة إلى العمل. لماذا ا؟ لأن صاحب العمل ، المنغمس بعمق في التفكير التجريبي وبالتالي الآن غير قادر تمامًا على الوثوق بكلمة قريبي الشاب أو بقدراتهم الخاصة في المراقبة ، يصر على أنه يجب أن يكون قادرًا على تقديم اختبار سلبي أولاً. حسنا خمن ماذا؟ لا توجد الآن تقريبًا مثل هذه الاختبارات المتاحة في المنطقة الحضرية بأكملها التي نعيش فيها. ولذا فهو يجلس بصحة جيدة تمامًا ولا يحصل على أجر في شقته.
هذا جنون.
نحن ، تحت ضغط ما يمكن القول أنه أكثر حملات إدارة الإدراك طموحًا وتنسيقًا في التاريخ ، نمتلك بعضًا من غرائزنا الإدراكية والسلوكية الأساسية التي تولدت بسرعة من حياتنا. والأسوأ من ذلك ، أن معظم الناس لم يستوعبوا أو حتى يفكروا في الأسباب الفعلية لفعل ذلك ، وما ينذر به جميعًا لمستقبل كرامة الإنسان وحريته.
الهدف الأساسي لجميع النخب الاجتماعية هو اكتساب قوتها والحفاظ عليها. وبالنسبة للجزء الأكبر ، فهم يدركون تمامًا التكلفة وعدم الكفاءة في القيام بذلك من خلال التطبيق المستمر للقوة البدنية.
هذا هو السبب ، كما أوضح عالم الثقافة العظيم إيتمار إيفين زوهار بوضوح مقنع ، فقد أنفقوا منذ ظهور الحضارة السومرية مبالغ هائلة من الطاقة والمال على حملات التخطيط الثقافي المصممة لتحقيق ما يسميه "الانطباع" على نطاق واسع بين عامة الناس.
باختصار ، يعرف الأقوياء أن خلق حقائق ثقافية تسمح لهم "بالدخول إلى رؤوس" الأفراد العاديين وعائلاتهم هو المعيار الذهبي لصيانة الطاقة وتمديدها.
للأسف ، خلال الأشهر الـ 22 الماضية ، لم يقاوم ملايين الأشخاص حول العالم هذه المحاولات للتطفل على كرامتنا الفردية والجماعية فحسب ، بل رحبوا بهم ، في حالتهم النفسية الضعيفة ، في حياتهم بأذرع مفتوحة.
وسيبقون هناك ، حتى يقرر المزيد منا أننا نريد إعادة تحمل المسؤوليات الأساسية لمرحلة البلوغ النفسي وإعادتها بقوة إلى المستودع المظلم للتقنيات الاستبدادية الكلاسيكية من حيث تم سحبها من قبل السياسيين العاملين بأمر من الدولة العميقة ، Big Capital ، Big Pharma و Big Tech.
نشرت تحت أ ترخيص Creative Commons Attribution 4.0
لإعادة الطباعة ، يرجى إعادة تعيين الرابط الأساسي إلى الأصل معهد براونستون المقال والمؤلف.