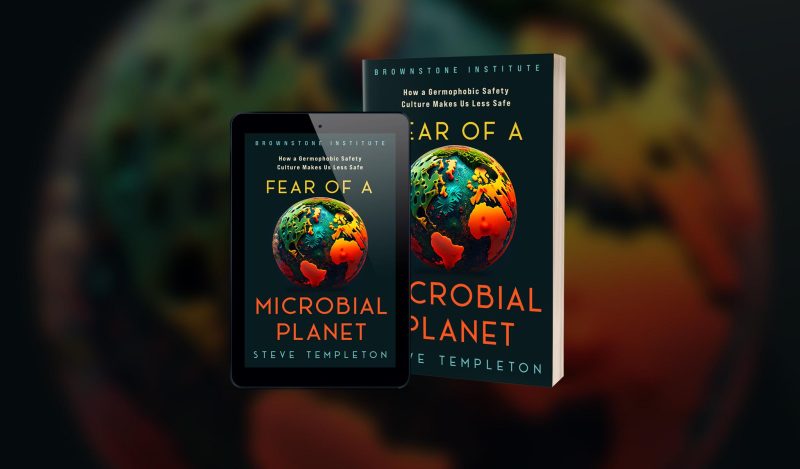هل فكرت يومًا في المعتقدات أو الصور الذهنية التي أنشأها عقلك حول كلمات معينة عندما كنت طفلاً ، قبل أن تحصل على المعلومات السياقية اللازمة لفهم القيمة الخاصة التي كانت لديهم للبالغين الذين سمعت عن استخدامها؟
أنا افعل.
على سبيل المثال ، أتذكر عشاء عيد الفصح منذ فترة طويلة مع عائلتي ، وعمي ، وعمتي ، وأجدادي ، وكيف ، بعد الانتهاء سريعًا من الحلوى ، تسلقت تحت الطاولة الطويلة "غير المرئية" (غمزة ، غمزة) مصممة على فك ربط خلسة أحذية الكبار بينما استمروا في متابعة حالة العالم. في مرحلة ما خلال زيارتي إلى هذا العالم الغامض ذي الجدول الفرعي ، تحولت المحادثة أعلاه لسبب ما إلى ما يجري في تركيا واليونان.
على الرغم من أن ذاتي التي ما زلت متعلمة يمكن أن أشعر من السياق أنهم كانوا يتحدثون عن أماكن بعيدة ، فإن كل ما يمكنني التفكير فيه ورؤيته في ذهني هو الديك الرومي الذي أكلناه للتو ، و "الشحوم" التي رأيتها في أسفل صينية التحميص قبل أن تستخدمها أمي لصنع المرق.
لعدة سنوات بعد ذلك ظهرت تلك الصور السخيفة للديك الرومي (الطائر الصالح للأكل) والشحوم (الشيء الذي يأتي من ذلك الطائر عند طهيه) في كل مرة أقرأ فيها ، أو سمعت أحدهم يذكر ، هذين البلدين. بمرور الوقت ، تلاشت هذه الصور واستبدلت في ذهني بصورة للدولتين على الخريطة ومع صور تاريخية وثقافية متنوعة أتيت ، عن حق أو خطأ ، لربطها بتلك الأماكن.
ما وصفته أعلاه هو عملية طبيعية مع معظم الناس عندما يتعلق الأمر بعناصر اللغة التي تمثل أشياء أو مفاهيم غير موجودة في بيئتنا المادية المباشرة ، وهي فئة من الظواهر التي تتضمن نسبة عالية من المحتوى الذي نتعلم عنه في الإعدادات التعليمية الرسمية.
يمكن للمدرب الجيد أن يقدم لنا عرضًا أوليًا للمراسلات بين مصطلح لغوي معين والواقع الذي يُقال إنه يمثله. ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، نتراجع عن ممارسة تقديم تخمينات متعلمة فيما يتعلق بعلاقات الواقع والرمز في عالمنا.
من خلال هذه العملية الأخيرة من التجربة والخطأ ، يكتسب معظم الناس في النهاية القدرة على "تسمية" بنجاح معظم الأشياء التي يتعاملون معها أثناء حياتهم المنزلية والعملية.
ويبدو أن العديد من الأشخاص ، إن لم يكن معظمهم ، راضون عن ترك انعكاساتهم حول طبيعة العلاقة بين الكلمات والرموز التي نستخدمها لوصفها هناك.
العديد من الآخرين ، ومع ذلك ، ليسوا كذلك. يدرك عشاق الكلمات هؤلاء ، صراحةً أو ضمناً ، ما وصفه سوسير بالأساس الطبيعة التعسفية للعلاقة بين العلامة اللغوية والشيء الذي تسعى لتمثيله ، وبالتالي إلى حد كبير الطبيعة المرتبطة بالسياق من المعنى اللفظي ، وبالتالي يحاولون باستمرار فهم الدلالات المتعددة لكلمة معينة.
على الرغم من عدم ذكره بشكل مباشر في كثير من الأحيان بهذه الطريقة ، فإن تعليم الناس إدراك الطبيعة متعددة التكافؤ للغة ، والطريقة التي يمكن أن تتغير وفقًا للسياق الذي يتم استخدامه فيه ، كان دائمًا أحد الأهداف الرئيسية للتعليم الإنساني.
لماذا ندرس الشعر ، على سبيل المثال ، إن لم يكن لصقل القدرة على الفهم ، وربما الأهم من ذلك البحث عن معنى ، الحقائق التي تقع خارج مستويات الخطاب الأكثر وضوحًا ونقل المعلومات؟
عندما نبحث عن معاني قد تتجاوز تلك التي لوحظت في قراءتنا الساذجة الأولى لقصيدة أو قطعة أخرى من الأدب ، فإننا نستخدم بشكل فعال مخزوننا المكتسب من المعرفة الثقافية وخيالاتنا البناءة "لملء" المقترح ، ولكن ليس بشكل واضح ، يحتاج السياق إلى "المعنى الكامل" (في حالة وجود مثل هذا الشيء) للنص.
هل يمكن أن يؤدي القيام بذلك في بعض الأحيان إلى مطاردات جامحة وتكهنات مسدودة؟ بدون شك.
لكن عدم القيام بذلك ، وعدم تعليم الصغار القيام بذلك ، هو أكثر خطورة بكثير.
وهذا لسبب بسيط للغاية.
يجب أن تستند أي محاولة لفهم العالم بطريقة تحترم تعقيده الذي لا يسبر غوره إلى افتراض أن هناك دائمًا العديد من المسارات غير المرئية في البداية ، أو المسارات الواضحة جزئيًا فقط من الترابط الذي يضفي على الحقائق الموجودة في وسطنا القوة والمعنى.
هذا صحيح بشكل أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة فهم اتساع الطبيعة. وعلى الرغم من أن الكثيرين يكرهون الاعتراف بذلك ، إلا أنه صحيح أيضًا عندما يتعلق الأمر بمهمة فهم الوسائل التي قامت من خلالها مراكز القوة الاجتماعية بهندسة "حقائق" ثقافية لبقيتنا عبر التاريخ.
بعبارات مختلفة قليلاً ، فإن التنظير أو التكهنات القائمة على مدخلات جزئية (تخضع لاحقًا ، بالطبع ، لسلسلة من اختبارات التحقق) هي الخطوة الأولى التي لا مفر منها في عملية تحويل أكوام المعلومات غير المهضومة من حولنا إلى معرفة.
ومع ذلك ، في كل مكان أنظر فيه إلى العكس تمامًا ، يتم القيام به وتشجيعه.
يُقال لنا أن الكلمات المحرومة من أي مجموعة واضحة أو مفهومة من المراجع الموضعية لها معاني ثابتة وغير متغيرة ، والأكثر سخافة ، أنه إذا كانت هناك كلمة أخرى لها تاريخ دلالي مميز تمامًا يذكر شخص ما بطريقة ما كلمة أو مصطلح آخر يُفترض أنه أحادي الدم ، يجب على جميع الآخرين الانضمام إلى "واقع" ذلك التعريف المفسر شخصيًا ، بغض النظر عن المعايير المقبولة على نطاق واسع لاستخدامه الحالي!
لقد رأينا مثالًا كلاسيكيًا للممارسة الأولى ، كما أوضحت في كتابي الجديد، مع استخدام مصطلح "الحالات" خلال الجزء الأكثر محملة بالهستيريا من الوباء.
هل قدم لك أي شخص نسبة ثابتة يمكن الاعتماد عليها بين نمو ما يسمى بالحالات والاستشفاء والوفيات؟ لا لم يفعلوا ذلك ، لأن مثل هذه الحسابات إما لم تكن موجودة أو لم يتم الإعلان عنها في حالة وجودها.
هل تم إخبارك أنه قبل ربيع عام 2020 لم يتم استخدام مصطلح "الحالة" للإشارة إلى الأشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية في غياب الأعراض الجسدية كما لاحظها الطبيب؟ أو أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل المستخدمة كانت تُجرى على 40-45 دورة تضخيم عندما كان معروفًا أن أي شيء يزيد عن 33 دورة (حتى أن بعض الخبراء قالوا 27 دورة) من التضخيم يولد كميات هائلة من الإيجابيات الخاطئة؟
لا ، كان من المفترض أن "تستهلك" الدال العائم من "القضية" وقبول التكافؤ الدلالي المفرد المرعب الذي كانت الوسائط تربطه به عن طريق التكرار المقزز.
وإليك الجزء المخيف ، فمعظم الناس فعلوا ذلك بالضبط!
أتذكر شرح الكثير مما سبق ذكره لمحامي صديق لي مرة أخرى في مارس من عام 2020. كنت تعتقد أن شخصًا ما يعمل طوال اليوم في تحليل جودة الحجج من قبل الآخرين وتوليد حجج مقنعة خاصة به كان سيفهم على الفور الضعف المتأصل لمصطلح "الحالة" كما تم استخدامه آنذاك. لا. حدق بي مرة أخرى بهدوء. لم يكن لديه أي فكرة عما كنت أتحدث عنه ، ودون تقديم حجة مضادة كرر إيمانه بالأهمية الرئيسية لعدد القضايا.
والأكثر إثارة للرعب هو الاتجاه الثاني المذكور والذي يتضمن أشخاصًا بالغين ومتعلمين مفترضين للانخراط في ارتباط حر دلالي من النوع الذي انخرطت فيه كطفل في الرابعة من عمري في عشاء عيد الفصح منذ فترة طويلة ، والمطالبة بأن يكونوا شخصيًا بالكامل وعادة ما يكون مزعجًا. لا تُمنح "تفاهمات" كلمة أو فعل كلام شرعية واسعة في الساحة العامة فحسب ، بل تُستخدم أيضًا كأساس لمعاقبة الشخص الذي كتبها أو نطق بها أخلاقياً.
ربما يكون المثال الأكثر سخافة وإثارة للشفقة لهذه الظاهرة الأخيرة هو محاولات متسلسلة لمعاقبة الناس على استخدام كلمة شجاع - التي ليس لها علاقة اشتقاقية معروفة باللون أو العرق ، وبالتالي المصطلح المهين للأميركيين من أصل أفريقي المحظور الآن - في الأماكن العامة.
من السهل أن تضحك على المحاولات السخيفة لوضع تلك الكلمة بالذات في محاكمة علنية. وفي حين أنه من الصحيح أنه عندما جاء الدفع في معظم الحالات التي حدث فيها ذلك ، فإن الأشخاص المعنيين بالفصل في الأمر تصرفوا بشكل عقلاني بشكل عام ، ما زلنا لا نرتاح بسهولة.
ذلك لأن المنطق ، كما هو ، لهذه الميول نحو التسطيح الدلالي العدواني وإزالة السياق الراديكالية والمصلحة الذاتية للكلمات والعلامات المرئية المفهومة منذ فترة طويلة حاضرة إلى حد كبير في ما يمر لخطاباتنا العامة.
فكر في حقيقة أن الموسيقار روجر ووترز ، وهو مناهض للنازية ، توفي والده وهو يقاتلهم في الحرب العالمية الثانية ، يخضع الآن للتحقيق من قبل الحكومة الألمانية لأدائه نقلاً قصيرًا قام به على خشبة المسرح لمدة 40 عامًا يرقص فيها على النازية. -مثل الزي واللباس المرتفع يذكّر جمهوره بالقسوة المروعة التي ارتكبت باسم تلك الحركة السياسية.
هل اهتم أحد بسؤال روجر ووترز عما إذا كانت نيته تمجيد النازية؟ أو أن نسأل الآلاف ، إن لم يكن الملايين من الأشخاص الذين شاهدوا هذا الفعل على مر السنين عما إذا كانوا يشعرون بأنهم طرف في طقوس تمجيد للنازية أو ، على العكس من ذلك ، نقد لاذع لتلك الأيديولوجية؟ أو إلقاء نظرة على المعلومات السياقية التي يسهل الوصول إليها والتي توضح أن فعل ووترز الصغير كان ، وكان دائمًا ، هو الأخير من هذين الأمرين.
لكن من الواضح أن الحكومة الألمانية الحالية لا يمكن أن تنزعج من كل هذه "التعقيدات" التفسيرية. بالقفز على Monosemic Express العظيم ، قرر أن التاريخ والسياق غير ذي صلة ، وأن ذلك ذكر أو إيماءة مرتجلة لأي شيء نازي ، حتى للاستهزاء به أو انتقاده بشدة في حد ذاته سيء وغير مقبول.
والأسوأ من ذلك ، يبدو أن لديها الثقة المبررة للأسف بأنها قادرة على إقناع جزء كبير من السكان بقبول هذه النسخة الجديدة المبسطة والمنزلة عن سياقها للظاهرة المعنية.
هذا هو بالضبط ما تم القيام به خلال ما يسمى بالوباء.
هل التشكيك في الحاجة إلى لقاحات mRNA ، أو ملف الأمان الخاص بها يجعلك حقًا شخصًا يعارض جميع اللقاحات بشدة؟ هل تعلم وقول بناءً على تحقيقاتك الدقيقة أن مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء ، بحكم علاقتهما بشركة Big Pharma ، غير قادرين على تزويد المواطنين بأي شيء قريب من النصائح التي تركز على المريض ، وبالتالي "توصيات" منهم يجب أن تؤخذ مع عدة ملاعق صغيرة من الملح ، هل تجعلك حقًا عدوًا أو كارهًا للعلم؟
هل قررت عدم أخذ لقاح لأن لديك مناعة طبيعية ، وبعد قراءة تقارير الإحاطة الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات عندما تم طرحها ، علمت أنه لم يتم اختبارها أبدًا لقدرتها على وقف انتقال العدوى ، فهذا يعني حقًا أنك كنت نوعًا من المعتل اجتماعيًا ، غير مهتم بحياة مواطنيك؟
الإجابة الواضحة على كل هذه التساؤلات "بالطبع لا!" لكن هذا ما قيل لنا بصوت عالٍ ، مرارًا وتكرارًا ، مرة تلو الأخرى.
من بعض النواحي ، هذا مجرد عمل كالمعتاد. لطالما استخدم الأقوياء سيطرتهم المفرطة على وسائل الإنتاج الثقافي لتحديد وتبسيط وصول الجمهور العريض إلى مجموعة كاملة من الإمكانيات الدلالية و / أو التفسيرية لإشارة أو كلمة أو مفهوم معين.
ما يبدو أنه جديد ، على الأقل في سياق العصر الحديث الذي ما زلنا نعيش فيه ، هو السلبية المذهلة للنخب المعتمدين لدينا قبل هذه الجهود.
هذا ، بدوره ، يتحدث عن الفشل الدراماتيكي لمؤسسات التعلم التي تميل ميكانيكيًا أكثر من أي وقت مضى.
إذا أردنا كسر هذه الدورة التنازلية المحبطة نحو الإنتاج والقبول اللطيف للحرفية العدوانية في ثقافتنا ، فيجب علينا توفير مساحة أكبر في هذا العصر من الشاشات وهذا التناقض المسمى "اللعب الخاضع للإشراف" لنوع السحر الابتكاري باللغة التي من ذوي الخبرة تحت طاولة عيد الفصح منذ فترة طويلة.
وهذا يعني إعطاء الأطفال وقتًا للعب بالكلمات ، وربما الأهم من ذلك ، سماعها من خلال مجموعة متنوعة من الأصوات شخصيًا ، وبالتوافق مع القدرات التواصلية المعجزة والمتفردة للغاية التي يضيفها وجه وجسد كل متحدث إلى عملية التواصل.
هذا فقط بعد أن يكتسب الطفل وعيًا بالمرونة العجيبة والطبيعة المتعددة التكافؤ لهذه الكورس البشري من حوله ، ويبدأ العملية الرائعة التي تحركها الأنا لاختراع روابط الكلمات (مهما كانت "إبداعية" وغير صحيحة في البداية) من تلقاء نفسه أننا يجب أن نبدأ بخفة من أي وقت مضى لتوجيهه في التعريفات "الصحيحة" للأشياء.
التدخل مبكرًا أو بقوة أكبر باسم الصواب ، ربما بدافع الرغبة في جعله يتفوق في اختبارات لا معنى لها وغالبًا ما تكون جوهرية تُعطى في سن مبكرة جدًا ، هو خطر القضاء على الإحساس الشخصي بالتعجب اللغوي والابتكار والقوة سيحتاج إلى الوقوف في وجه جيش المبسّطات الدلالية المنتشرة حوله.
من المألوف جدًا حاليًا في دوائر معينة التحدث عن المرونة العاطفية. ما لا يبدو أن أحد يتحدث عنه هو المرونة الإدراكية أو الفكرية ، وكيف يتمزقها تحت ضغط الحرفيين الدلاليين أمام أعيننا.
اللغة هي أداة رائعة ومعقدة بشكل مثير للدهشة ، إذا تم شحذها بشكل صحيح ، فإنها تسمح بإدراك التفاهمات الدقيقة للعالم والتعبير عنها ، ومن هناك ، خلق خيالي لآمال وإمكانيات جديدة.
ألم يحن الوقت لأن نبدأ مرة أخرى في أن نضع أنفسنا نموذجًا لأنفسنا ، والأهم من ذلك ، صغارنا ، هذه الحقيقة الأساسية؟
نشرت تحت أ ترخيص Creative Commons Attribution 4.0
لإعادة الطباعة ، يرجى إعادة تعيين الرابط الأساسي إلى الأصل معهد براونستون المقال والمؤلف.