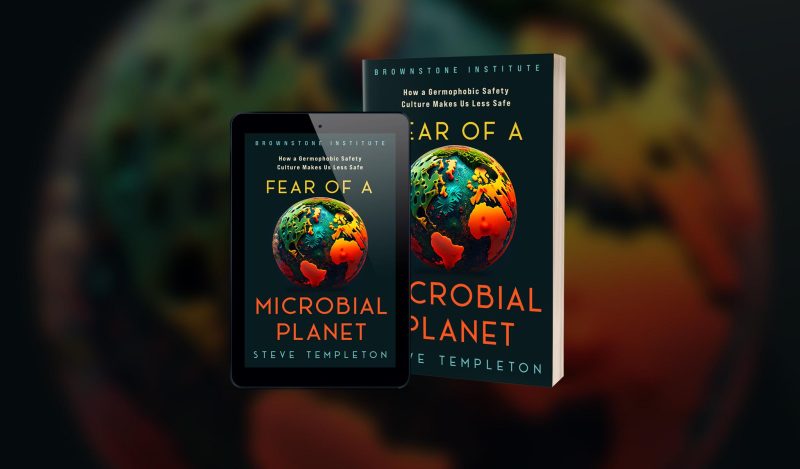خلال الصيف ، تلقيت بريدًا إلكترونيًا من سكرتيرة الكلية "الخاصة بك" - حيث تحب أكثر من يشغل منصبًا مؤيدًا للإدارة في الذاكرة الحديثة الإشارة إلى نفسها في ملاحظات لزملائها - تدعوني للمشاركة في جلسات العلامة التجارية التي يديرها استشاري عينته الكلية مؤخرًا.
لذا ، فقد وصلت أخيرًا إلى هذا ، كما اعتقدت. نحن ، مجموعة من المفكرين المدربين بإسراف ، قد تخلينا عن الادعاء بأن الأفكار والحجج مهمة بصرامة ، واستسلمنا أخيرًا لمنطق ما أسماه زيجمونت باومان بحكمة "الحداثة السائلة" ، وهي مساحة يتم فيها تصنيع الصور المحتملة و تتفوق الأحاسيس بانتظام على أفراح ودروس التجربة الأولية.
أنا لست ساذجًا بشأن الواقع المحسوب والمحسوب في كثير من الأحيان لعرض الذات ، ولا الدور الهائل الذي لعبته في الشؤون الإنسانية عبر التاريخ. كانت هناك ، وستظل دائمًا ، فجوة في ما نعتقد أنه في جوهره إلى حد ما وفي الوجوه المختلفة التي نقدمها للعالم.
ما يثير القلق اليوم هو كيف يبدو الآن أن التوازن في هذه الثنائية الحالية يميل بشكل مفرط نحو فنون الخداع ، والموقف الذي بدأت فيه الحبال المتوترة دائمًا التي تربط بين العناصر الأساسية وعناصر الحياة التي يمكن تصويرها تنفجر.
منذ وقت ليس ببعيد ، كان يُنظر إلى تنمية الفصل بالجملة بين الأفكار الداخلية للفرد والعرض الخارجي على أنها مرضية. الآن ، ومع ذلك ، فإن القدرة على نشر الصور الحرة العائمة للذات (ومعها الأسباب المختارة للفرد) يتم تقديمها الآن كدليل على الحس السليم والذكاء العالي.
فكر فقط في الملايين من الشباب الذين يقضون الآن وقتًا أطول بلا حدود في تنسيق شخصياتهم عبر الإنترنت بدلاً من معرفة من هم وما يؤمنون به من خلال الحوار وجهًا لوجه.
يتم اشتقاق العلامة التجارية من المصطلح الإنجليزي الأوسط "لإقناع أو حرق علامة بمكواة ساخنة ، للكي ؛ لوصم العار "، وهي ممارسة ذات نية مؤلمة وانتهاكات واضحة عند زيارتها ، كما كانت في كثير من الأحيان في الماضي ، على إخواننا من البشر.
عندما نقوم بكي الجسد البشري فإننا ، في الواقع ، نلغي علاقته ببقية الكائن الحي الذي يشكل جزءًا منه ، ونبدأ عملية تسخر من الوعد بـ "الرمز الحقيقي" الفادي الذي ، وفقًا لجوزيف كامبل ، هو "دائمًا رمز مميز يستعيد ، بطريقة أو بأخرى ، نوعًا من الوحدة المعطلة."
ما الذي نخسره عندما يصبح هذا الفصل بين الأجزاء والكلمات أمرًا طبيعيًا في ثقافة ما ، عندما تكون عقولنا "محفورة" باستمرار من خلال تمثيلات أحادية البعد لحقائق معقدة بطبيعتها؟ يبدو أنه سؤال يستحق الاستكشاف.
بينما كانت العلامات التجارية السياسية معنا دائمًا ، يبدو أنها اتخذت قفزة نوعية في الجرأة والشدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرينst مئة عام. أولاً جاءت الحملة الدعائية الضخمة "معنا أو ضدنا" لصالح تدمير العراق.
ثم جاءت حملة أوباما للرئاسة ، حيث أفسح التقليد طويل الأمد المتمثل في جلد مجموعة جذابة من الصور مع الحد من إصدار التزامات سياسية ملموسة الطريق لممارسة التركيز بشكل شبه حصري على الأولى على حساب الثانية.
في ذلك الوقت ، أتذكر إجراء محادثة تلو الأخرى مع ناخبين ديمقراطيين متعلمين واثقين من أن أوباما سيكون رئيسًا تقدميًا رائعًا ، الأشخاص الذين ، عند الضغط عليهم ، لم يتمكنوا عمومًا من الإشارة إلى أي مقترحات سياسية ملموسة أدت بهم إلى هذا الاستنتاج.
وعندما تمت الإشارة إليهم أنه قام بعدد من التحركات في مسيرته السابقة على السياسة ووقته القصيرة في مجلس الشيوخ مما جعله مؤيدًا موثوقًا به إلى حد ما لمراكز القوة المالية والعسكرية التقليدية والمحافظة عمومًا ، معظمهم لن يسمعوا به.
وسارعت الأقلية التي ستتعامل مع مثل هذه التحديات في التوضيح ، في ظل عدم وجود أي دليل موثق (تذكر أوباما كلاعب شطرنج ثلاثي الأبعاد؟) أنه إذا كان يقول ويفعل هذه الأشياء غير البديهية ، فسيتم انتخابه. ، وأن كل هذا سيتغير من أجل الصالح التقدمي عندما تولى المنصب أخيرًا.
ببساطة حالة ناخبين منهكين من الحرب يتقدمون على أنفسهم؟ كان هذا بلا شك عاملا.
ولكن بالنظر إلى ما نعرفه الآن عن الدور المهم الذي لعبه "المحامي العام Nudge" Cass Sunstein في إدارة أوباما ، فإن الشراكة شبه السلسة التي قام بها 44th سيستمتع الرئيس مع رئيس التجسس والمسلسل سينوغرافي العمليات النفسية جون برينان ، و الدور الضخم الذي تلعبه الآن فرق البصيرة السلوكية على جميع المستويات الإدارية في مجتمعنا ، يبدو أنه من المشروع أن نتساءل عما إذا كان هناك شيء أكثر تخطيطًا ومنهجية قد يحدث.
عندما نأخذ الوقت الكافي للاستماع بعناية لأولئك الأقرب إلى السلطة (الذين في تجربتي المحدودة معهم غالبًا ما يكون لديهم طريقة خارقة لخيانة أفكارهم ونواياهم الحقيقية) ، يصبح من الواضح أنهم كانوا يفكرون في كيفية الترويج لهذه الأنماط المعرفية فصل في عموم السكان لفترة طويلة.
عندما أخبر كارل روف في مقابلة شهيرة عام 2004 رون سسكيند عن قدرة إدارة بوش على خلق "حقائقها الخاصة" - أي الحقائق الافتراضية التي من شأنها أن تفوق دائمًا قدرة الصحفيين وغيرهم في ما أسماه "المجتمع القائم على الواقع" "لإبطال مفعولها في أذهان الجمهور - كان يقوم بذلك بالضبط.
أظهر رام إيمانويل صراحة مماثلة في عام 2010 عندما طُلب منه التعليق على الاستياء الليبرالي المتزايد من تخلي الرئيس أوباما المتسلسل عن وعود حملته الانتخابية ، فقال: "إنهم يحبون الرئيس ، وهذا كل ما يهم" ، والذي يبدو أنه حقًا عنى شيء من هذا القبيل.
لقد استثمرنا الكثير من الوقت والمال في خلق صورة للرئيس تناشد الليبراليين الباحثين عن الفضيلة. تخبرنا استطلاعات الرأي التي أجريناها أنه عندما يُجبرون على الاختيار بين تلك الصورة التي تم إنشاؤها بعناية لأوباما وما تخبرهم به أعينهم الكاذبة عن الطبيعة الحقيقية لسياساته ، فإن معظمهم سيختار الأول. وبالطبع ، إذا لم ينجح هذا ، فيمكننا دائمًا مضاعفة الحديث عن كيف أن الجمهوريين أسوأ بكثير ".
يبدو من الواضح بشكل متزايد أن النشطاء السياسيين لدينا ، وائتلاف الدولة / الشركات العميقة الذين يعملون لصالحهم في الغالب ، يثقون الآن بعمق في قدرتهم على استخدام العلامات التجارية للحث على ما يقترحه عالم النفس الاجتماعي ألبرت باندورا هو التنشيط الانتقائي وإلغاء تنشيط الأخلاق العامة للجمهور. الغرائز.
لقد وجد النتيجة الثانية ، التي وصفها بـ "فك الارتباط الأخلاقي" على أنها مقلقة بشكل خاص لأنها يمكن أن تفتح الباب أمام نزع الصفة الإنسانية على نطاق واسع عن أولئك الذين يرفضون التخلي عن وكالتهم الشخصية في خضم الضغط للتوافق مع النخبة الخاصة. -إلهام ، فكر جماعي في اللحظة.
وهنا ، وفقًا لباندورا ، توجد بعض السمات المميزة للظاهرة.
قد يتركز فك الارتباط الأخلاقي على إعادة الهيكلة المعرفية للسلوك غير الإنساني إلى سلوك حميد أو لائق من خلال التبرير الأخلاقي ، وتعقيم اللغة ، والمقارنة المفيدة ؛ التنصل من الشعور بالوكالة الشخصية عن طريق نشر المسؤولية أو إزاحتها ؛ تجاهل أو التقليل من الآثار الضارة لأفعال الفرد ؛ وإسناد اللوم إلى الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم. تعمل العديد من الأعمال اللاإنسانية من خلال شبكة داعمة من المؤسسات المشروعة التي يديرها أشخاص محترمون بطريقة أخرى يساهمون في الأنشطة المدمرة من خلال التقسيم الفرعي المنفصل للوظائف ونشر المسؤولية. بالنظر إلى العديد من الآليات لفك الارتباط الأخلاقي ، تتطلب الحياة المتحضرة ، بالإضافة إلى المعايير الشخصية الإنسانية ، ضمانات مدمجة في النظم الاجتماعية التي تدعم السلوك الرحيم وتنبذ القسوة.
هل يمكن أن يكون هناك وصف أفضل للسلوك على مدى العامين الماضيين - يجب أن يقال - بشكل ساحق لمجموعة "ليبرالية" وذات مصداقية جيدة من المتطرفين Covid في وسطنا؟
نعم ، كانت إدارة بوش ، التي عملت على ما تعلمته عن إدارة وسائل الإعلام من غزو بنما وحرب الخليج الأولى ، هي التي وضعت أولاً آلة خلق الواقع لكارل روف في حالة تأهب قصوى.
لكن ما يسمى بالتقدميين هم الذين جلبوا سياسة العلامة التجارية - بهجماتها المفتوحة على أولئك الذين يطالبون بالتحليل التكاملي وحل المشكلات - إلى آفاق جديدة ، أولاً من خلال إنكارها للتغطية على نزعة أوباما الوضيعة و الترويج للحرب ، ثم سعيها الخالي من الحقائق لفضيحة Russiagate والآن ، وربما الأكثر تبعية ، نهجها المستمر في إنكار الواقع تجاه Covid.
لدينا هنا مجموعة سكانية ، يرتبط إحساسها بالهوية الاجتماعية والسياسية إلى حد كبير بفكرة أنهم أكثر بُعدًا وأكثر أخلاقية من أولئك الذين يعارضونهم في المناقشات الاجتماعية ، ويوقعون بكل سرور على الاعتقالات الجماعية الجماعية ، مؤكدة إطلاق النار. تحفيز التأخيرات المعرفية والنمائية لدى ملايين الأطفال ، والأكثر خطورة ، الإلغاء الصريح لمفهوم السيادة الجسدية. وكل ذلك في ظل عدم وجود أدلة تجريبية قوية على فعالية السياسات التي فرضوها و / أو أقروها.
ليس من المبالغة القول إن 20-30٪ من سكان الولايات المتحدة ، الذين يشكلون نسبة صحية من مواطنيها الأكثر اعتمادًا ، يعيشون الآن في حالة شرود دائمة حيث يتبعون توجيهات من السلطات الفكرية "ذات العلامات التجارية المناسبة" ، ويسخرون بشكل انعكاسي من أولئك الذين نفس السلطات تشير بسرعة على أنها شاذة. هذا النمط العقلي يطغى باستمرار على أي رغبة من جانبهم في الانخراط في مراجعة مستقلة للبيانات المتاحة.
مثال اسبانيا
ليست هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها نخبة إمبراطورية مهووسة برموز قدرتها المطلقة على نفسها عقلياً بهذه الطريقة.
في منتصف ال 16th القرن كانت القوة السياسية والاقتصادية والثقافية لإسبانيا هائلة ، ويمكن مقارنتها من نواح كثيرة بقوة الولايات المتحدة في العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. لم يكن هناك شيء يحدث في قوس يمتد من تشيلي إلى فيينا مروراً ببيرو وكولومبيا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان المنخفضة ومعظم أوروبا الوسطى ومعظم شبه الجزيرة الإيطالية محصنًا من قوتها.
لم يقم الفاتيكان ، الذي كان لا يزال مركز الحياة الدينية لمعظم المواطنين في هذه الأماكن ، بأي حملة أو تغيير كبير دون التفكير أولاً في كيفية رؤيته في Escorial ، المقعد المبني لإثارة إعجاب الملوك الإسبان بالخارج. مدريد.
ومع ذلك ، في نهاية الربع الأول من 17th قرن ، كان من الواضح أن اللحظة الإسبانية قد ولت. نعم ، كانت هناك - ومن الجدير بالذكر - حروب باهظة الثمن وسوء الاختيار وسياسات اقتصادية كارثية تجنبت الاستثمار المحلي لصالح ما قد يطلق عليه اليوم الاستعانة بمصادر خارجية للمصنعين الأجانب والمدفوعات للدائنين الأجانب. ولكن ربما كان الأهم من ذلك ، أنه كان هناك فشل عام للنخب في البلاد في التعرف على الحقائق المتغيرة للعالم والتكيف معها.
مع تقدم إنجلترا والدول المنخفضة للأمام في تطوير المنهج العلمي ومبادئ الرأسمالية الحديثة ، وبالتالي خلق حتمية لإعادة ترتيب مجموعة الدول الأوروبية ، سخرت إسبانيا أولاً من مناهجها الجديدة ثم سعت إلى إعادتها. في أماكنهم الصحيحة رغم الحروب باهظة الثمن والمهدرة.
ما نادرًا ما فعلته النخب الإسبانية ، مع استثناءات قليلة ، هو التوقف وطرح أسئلة صعبة حول التعاليم التي كانوا يمارسون الأعمال بموجبها ، وماذا ، إذا كان أي شيء يفعله هؤلاء الذين يكسبونهم ، قد يكون جديرًا بالتقليد. على العكس من ذلك ، كانوا يميلون إلى فرض المزيد من الرقابة الصارمة وتنظيم حملات ازدراء للأجانب وأفكارهم.
بقية القصة ليست جميلة وتدور خلال القرون الثلاثة القادمة أو نحو ذلك حول الإفقار التدريجي والحروب الأهلية المتكررة والتراجع إلى حالة الركود الثقافي والسياسي.
ومع ذلك ، كان من العظماء استمرار الغطرسة والاعتقاد الوهمي في مكانتها كواحدة من الأقطاب العظيمة للثقافة العالمية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لدرجة أن قيادة البلاد حظرت بفخر كتب المفكرين البارزين في الفكر المعاصر ووصفت نفسها بأنها بلا خجل وغير متجانسة. "حارسة الثقافة الغربية."
هل سيكون هذا مصيرنا؟
من أجل أطفالي ، لا آمل ذلك بالتأكيد.
إذا أردنا تجنب ذلك ، يجب علينا ، على ما أعتقد ، أن نذكر أنفسنا بفكرة كامبل عن "الرموز الحقيقية" وكيف ، قبل كل شيء ، تساعدنا في إصلاح ما تم كسره. بينما يجب علينا دائمًا دحض الأكاذيب التي يلقيها علينا صانعو الأفكار ذوو العلامات التجارية بشكل صريح ، لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نسمح لأنفسنا بالوقوع في دوامة تخيلاتهم الذاتية المرجعية عن الذات والآخرين.
القيام بذلك سيكون بمثابة استنزاف الطاقة من وظيفتنا الرئيسية المتمثلة في توليد الإصلاح النفسي والروحي الذي ، كما جادل مفكرون مثل ماثيو كروفورد وجوزيب ماريا إسكيرول ، وكما جادل سينيد ميرفي ذكرنا في مقال جميل نشر أمس هنا في براونستون ، لا يمكن أن يأتي إلا من إقامة روابط ارتباطية قوية.
تم إنشاء السندات ، ليس على أساس توجيهات من أعلى إلى أسفل ، ولكن من تقدير صريح لحالاتنا الفردية من الهشاشة ، ومعرفتنا أن الشيء الوحيد الذي أنقذنا من تلك الحالة هو حسن النية ، والعين- اجتماعات مباشرة عبر طاولات العشاء ، ومنضدة العمل ، ومجموعات سجل القصاصات ، أو في أي مكان آخر يجتمع فيه الناس على أمل الاتصال وبناء أو تجديد شيء معًا.
نشرت تحت أ ترخيص Creative Commons Attribution 4.0
لإعادة الطباعة ، يرجى إعادة تعيين الرابط الأساسي إلى الأصل معهد براونستون المقال والمؤلف.